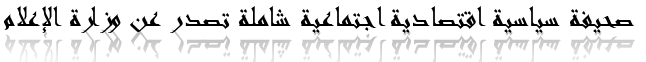في الشارع علي مقربة من مركز تدريب وتكوين المدرسين توقفتُ وصديقي علمي ننتظر دورنا لمقابلة لجنة انتقاء المدرسين، بعد تجاوزنا الامتحان التحريري كنا نتوقع أن يبدؤوا بنا نحن الآتين من المحافظات البعيدة ولكنهم خَيّبوا أملنا عندما شاهدنا لائحة العاصمة تتصدر القوائم فتراجعنا بعد محاولات متكررة ويائسة دون جدوى أسندت ظهري إلى السور الحجري أنفث دخان الملل بينما جلس خالد على الحافة يرقب الجموع... أصبحنا أشبه ببوابة الاستعلامات لكل من يسأل.
اقتربتْ منا في هذه اللحظة فتاتان إحداهما بيضاء البشرة ساحرة الجمال والأخرى ممشوقة القوام تميل إلى السمرة في رزانة واتزان المرأة الأنثى بكل ما تعنيه الكلمة.
قالت الأولى: لو سمحت أين يتم الامتحان الشفوي ؟
ـ هنا... وأشرت إلى باب المعهد . تفضلي على الرُّحب والسَّعة.
ـ حضرتك البواب؟
ـ أخدم الحلوات فقط.
ـ عظيم.. انتظرني إذن.. ودخلت مع رفيقتها التي كانت صامتة تصغي إلى ما يدور بيننا مبني كهرباء جيبوتي المجاور لحظات قليلة وعادت مسرعة: هل تسدي إليّ معروفاً يا.. ما اسمك إذا سمحت؟
ـ محمود
ـ أبح . اسمي أبح .
ـ وبماذا أخدمك يا أحلى أبح ؟
ـ عظيم تطوّرنا الآن.. من أي مدرسة أنت ؟
ـ محمود .. قلت لك ـ محمود.. من مدرسة الإرشاد يا آنسة أبح .
وقفت وحيداً أتلهَّف لعودتهما.. أستعرض ما جرى ثم أسرعت إلى المدرسة وتمكنت من المثول بين يدي اللجنة التي حاصرني أعضاؤها الثلاثة بعدد من الأسئلة عن التدريس والمادة والطرائق، تجاوزتها كلها وخرجت مزهواً في وفيما أنا أغادر البهو التقينا مجدداً... توقفت هي وتابعت الأخرى:
ـ ماذا؟ هل الأسئلة صعبة.
ـ لماذا تسألين؟
ـ أرجوك خذها ببساطة، وكن جاداً الآن.
ـ بجد أسألك أولاً ما اسمها؟
ـ من؟ تقصد ابنة خالي...
ـ إذا سمحتِ.
ـ وما شأنها.. أحذّرك فهي لا تحب المزاح.
ـ أنا لا أمزح أتصدقين لقد! لقد أعجبتني فعلاً.
ـ يعني أنا لم أعجبك.. انظر جيداً..
ـ في الحقيقة لا.. لم تعجبيني.
ـ يا للصفاقة، ارتق قليلاً يا. محمود . على ما أظن!
ـ لا أدري ماذا أقول.. كأنني أعرفها منذ زمن بعيد.
ـ إذا كنت تحاول امتهاني.. فمن أنت بالنسبة إلي...؟!
ـ لا بد أن أعترف أنكِ غَلبتنِي.. ومن النبل أن تساعديني الآن وهذا ما لا أظنه فيك.
ـ ارتحت الآن.. رددت، لا بأس.. اسمها حسنا هل تستمر أم تنسحب.
ـ يا إلهي.. ذات الاسم الذي أحب.
ـ إذن ستستمر.. لكن بعد المقابلة.. سأتفرغ لك.
ـ لا تشغلي نفسك.. فقط احملي إليها إعجابي وإذا لم تمانع فأنا أود التعرف بها.. أقسم إنني جاد.
ـ أتريد مني أن أقول لها: أنا اصطدت وأنت كلبي..
ـ بصدق.. هي.. يصعب الشرح ولكن أرجوك... أمّا الأسئلة.. ورحت أشرح لها وأفصّل...
بدأت الحكاية هكذا على شكل لعبة.. وجدتني بعدها نهب انتظار حقيقي ومباغت، أصحيح أنها طابقت تلك اللوحة التي أحملها في خيالي، هل لأنها تملك تلك الخصوصية التي تميزها عن الأخريات، أم أنها مجرد نهاية للعبة بدأت وحسب، لماذا هي بالذات مع أنها لم تنبس ببنت شفة.. رحت أسترجع صورتها على شاشة الوجدان.. قطعة من هدأه الليل بوحُ حلم لذيذ، رجع لشعور دافقٍ بالحنين أحببت فيها ذلك الكبرياء الصامت الرصين تلك النظرة العارفة بالمعاني وشيئاً من البساطة مثل النسيم.. أتراها تستجيب، آمل أن تفعل... فهدوءاً يا خفقان قلبي وسكوناً يا شعور...
انتهت مقابلات الالتحاق بمعهد المعلمين .. كانت حسناء آخر من خرج من اللجنة... لأول وهلة حسبتها ستمضي دون أن تعيرني أي انتباه ولكنها تقدمت نحوي بكل اتزان.. حدّقت بي ملياً..
ـ أمعقول تصرُّفك هذا؟
ـ أنتِ على حق.. لا يبدو كذلك..
ـ إذن انتهى الأمر.. شكراً لإعجابك.. وهمّت بالخروج.
ـ لا تفعلي أرجوك.. امنحيني لحظة من فضلك.
لاحظتْ انفعالي.. رمقتني بنظرة استغراب...
ـ ألا تعتقد أننا كبرنا على مثل هذه التصرفات..؟ أليس من الأنسب أن تبحث عن طريقة أفضل، أتظن ذلك ينجح دائماً.؟
ـ اسمعيني أرجوك.. لطالما أضحكني موقف ذلك الشاب البسيط الذي ما إن التقى بزميلته في الجامعة حتى راح يمطرها بالمشاعر وذوب الأحاسيس.. على أنني وأقسم في هذه اللحظة كنت أنتقدُ التهور وأنأى بقلبي عن السقوط ولكنك ولتقولي ما تشائين ولجتِ الباب الذي أوصدُته طويلاً خشية تذلل المحبين، وإذا كنت أحرص على استبقائك هنا وفي هذا المكان الذي أعتبره شديد المناسبة لما ترفضين فلأن خوفاً لازمني طويلاً قد انحسر الآن، وإذا كانت الكلمات قاصرة عن حمل المشاعر التي لا تهمك في هذا الموقف الصعب، وستكونين محقة في كل قرار تتخذين، فإنني أجدد القسم على صدق ما أقول بعيداً عن كلِّ احتمال أو خاطر يطرأ على البال، وأنت على كل حال سيدة الموقف فانظري ماذا ترين.
تنبهت من الذهول نظرت إليّ بعين فاحصة... اتصل ما بيننا خيط رفيع.
ـ هل تعرفني جيداً؟
ـ أجل ومنذ زمن بعيد.
ـ أنا لا أعرفك.. أسمع كلامك فحسب.. لا أظن أنك...
ـ لقد ورطت نفسك أنا نصحتك.. قالتها أبح متشفية.
ـ سأكون في ورطة حقيقية إذا لم تمنحيني الفرصة.
ـ ها أنت تمنح نفسك ما تريد.. ماذا بعد.
ـ لا تكوني قاسية هكذا يا حسناء.. أردفت أبح مستعطفة هذه المرّة وكأنها لامست ما أنا فيه.
ـ لم يعد هناك ما أقول.. شكراً لاستماعك.. وانسحبتُ مهزوم الخاطر مبعثراً على الطريق لا أدري ما أفعل وأنا لا أعرف سوى اسمها وصورة كانت في الذاكرة سترحل إلى المجهول. وقبل أن يُغيّبني الأفق سمعتُها تنده عليّ.. توقفتُ.. استدرت، هل هي الهواجس؟ أذلك رجع ندائي المخنوق أم؟ وقبل أن أتلاشى في زحمة ارتدادي رأيتها وأبح تسرعان الخطو إلي.. تلوّحان من جديد والتقينا كما يلتقي أي محبيَّن. كانت النظرة مختلفة تمام الاختلاف... الخطوة غير الخطوة.
ـ أتعدني بالوفاء؟
ـ أما زلت بحاجة إلى وعود؟
ـ أنا أقدّرك بحق.. لا أظن ما قلته إلا صادقاً.. على أنني ألمح فيك طيف شاعر مرهف، وهو أمر مقلق على أية حال.
ـ وهل يعيب المرء أن يكون كلامه مُوقّعاً بمداد القلب والمشاعر؟
ـ وقبل أن نغادر اتفقنا على موعد جديد شريطة أن يكون رسمياً هذه المرة.. كتبت لي رقم الهاتف والعنوان.. مدت يدها لتصافحني فأحسست بل أحسسنا معاً بذلك الخيط الرفيع يتوهج شعلة من ضياء ودفقاً من النقاء.. صار حباً.. ولكن ليس كأي حب هو أشبه بالولادة أو الاكتشاف. ـ محمود أعتذر عما بدر مني.. قسوت عليك كثيراً قالتها نغماً.. شعراً.. شيئاً أكبر من التعبير ـ هززت برأسي.. حملتها معي شمعة تضيء دربي ومضيت.
جمال أحمد ديني
- السبت 7 فبراير 2026