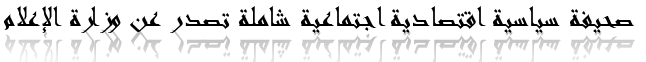في طفولتهما. لم يكن، يشك، من يراهما معاً.. أنهما توأمان فقد ولدا في سنة واحدة. و حي واحد. وفي بيتين متجاورين.
ورغم فقر أهليهما، المدقع، فقد كان لهما، دالة في أسرتيهما. استثمراها، في أمر واحد.. وهو عدم معارضتهما، في رفقتهما المستمرة. من الصباح، وحتى وقت النوم.
أدركا. في سن مبكرة.. أنهم فقراء. وأن هناك، بالمقابل، الأغنياء. كان حيهم الصغير يجمع بين بيوت الصفائح والبيوت الحجرية وأخري خشبية وبين هاتين الشريحتين من المجتمع
في المدرسة كانوا يلتقون ، جميعاً. هم، وأولاد الأغنياء، وأولاد الموظفين... لكن تلك الحدود الوهمية. لم تكن تفصل، فئة، عن أخرى، كانوا يجرون. ويقفزون معا. ويدفع بعضهم، البعض الآخر..
وأخذ الاثنين يكبران وأخذت أحلامهما تكبر، معهما. واكتشفا، فيما بعد. أن كل الناس.. يحلمون، مثلهم حتى حملا أهلية التعليم. وأصبحا معلمين، في نفس المدرسة التي درسا فيها المرحلة الابتدائية وفي هذه المرحلة، من حياتهما.. أحبا، مدينة وكان مصطفي يعلق علي الأمر بقوله:
لا عجب. أن نحب، سوية. فتاة واحدة. ألسنا كياناً واحداً، في اثنين. لكن العجيب، في الأمر. أن مدينة أحبت.. كلينا. وكانت في حيرة، من أمرها.. أينا تختار. إلا أنها اعترفت لي، بعد شهور. بأنها تحبني، أكثر قليلاً، من عبد الله. ولكنها لا تريد أن تغضب رفيقي. وكان رد فعلي. عجيباً أيضاً. عندما أخبرت مدينة . أني أنا أيضاً. أخاف أن يغضب عبد الله، مني، بسببها.
كان يبدو لنا. أن مشكلتنا مع مدينة ، لا حل لها. وكان هذا الأمر، يتفاقم، يوماً، بعد يوم. حتى خيل إلينا. أنه سوف يقضي، على علاقتنا. التي لم يكن يخطر، على بال أي منا. أن أي أمر. يمكن أن ينال منها.
وجاء الحل، من السماء. فقد حصل عبد الله، علي فرصة الهجرة إلي أوربا في تلك الفترة التي سجلت هجرة عدد من المدرسين بسبب الأزمة الاقتصادية وتأخر الرواتب.
وبقدر ما كان حزنه على مفارقة عبد الله، كبيراً. فقد كان الشعور بالذنب كبيراً أيضاً. لأنه فرح لسفر صديقه الذي جعل مدينة تصبح له، صافية.. وظل هذا الشعور بالذنب يؤرقه.. زمناً طويلاً.
وكانت الرسائل هي وسيلة حضور أحدهما أمام الآخر. رغم البعد. فقد تعاهدا عند الوداع. أن يجعلا بين الرسالة والأخرى، شهرا فقط. وأن يسطرا في الرسالة، حياتهما خلال شهر دون إغفال.. أي أمر. إلا أن مصطفى -رغماً عنه- كان يخفي عن صاحبه، تطور علاقته، بمدينة رغم أنه، وفي كل رسالة، كان يستحثه على الحديث، عنها.
ومرت سنوات أخرى. خلال آخر سنة. كانت رسائل ياسين ، تتناقص باستمرار. وكذلك عدد صفحاتها. ثم انقطعت رسائله، تماماً، وبدأ مصطفي يتمتم : من العجيب. أني كنت، قد توقعت، هذه النهاية. لأني، لم أكن أكتب له، إلا عن اليأس، الذي استقر، داخل نفسي. وكان يتفاقم، يوماً بعد يوم. وعن هذه الأيام. التي جعلتني أتحسر، على أحلامنا التي كنا نتعاطاها، ونحن صغار. لقد كانت أحلامنا، آنذاك. طليقة. ولم يكن ادراكنا القاصر. يتصور أن تقف أمام الأحلام أية قيود أو سدود. أحلامنا اليوم تحولت إلى كوابيس. فالراتب رغم أني كنت مستقلاً به. لم يكن يتحمل أن يرفع عليه أي بناء.
كان عليّ. أن أجمع مهر مدينة وأن أبني لها ولو غرفة صغيرة ضمن دار الأسرة، وفيما كنت أتخبط في حيرتي المستمرة منذ سنوات محاولاً أن أحل هذه المعادلة المستحيلة. عاد عبد الله من الغربة فجأة. وعندما التقينا ضممته إلى صدري بقوة، وأنا أغمره بقبلاتي والدموع تجول في عيني. بينما هو كان يضحك وهو يخلص نفسه، من بين ذراعي. وجلسنا على الأرض وأنا ما زلت أمسك بيده. ثم خلص يده من يدي وهو يقول:
-أول هدية ستكون من نصيبك..
ثم قام إلى إحدى الحقائب الكبيرة المرصوفة، في صدر الغرفة وأخرج علبة وقال:
-هذا من مستلزمات السياسي. أنت تحب الأخبار وهذا (الراديو) له عشر موجات يعطيك الأخبار، من كل إذاعات العالم.
شعرت بعد ساعة أن ذلك الحبل الذي يربطني مع ياسين وكأنه قد انقطع منذ زمن بعيد، حاولت أن أعيده إلى الماضي، لكنه هز يده بشدة كأنه يطرد الماضي.. بعيداً. عرضت عليه أن أعزمه علي جلسة قات لكنه اعتذر بشدة.
نسيت هديته، على الأرض وأنا أغادر المكان لحق بي، وهو يضحك. خيل إلي أنه غير رأيه وسوف يخزن معي اليوم دس الهدية بين يدي الممدودتين إليه وعاد سريعاً.. إلى ضيوفه.
وأنا أتوحد مع نفسي في فراشي آخر الليل وحتى وافاني النوم. عند الفجر، كنت أتعارك مع أفكاري السوداء التي أخذت تطبق علي من كل جهة.
في الأيام التالية تأكد أن عبد الله كان يتهرب من لقائه بشتى الحجج ولم يعد يصله به إلا أخباره التي كانت تتوالى من خلال الجيران
في اليوم الثالث من عودته..اشتري بيتا
في اليوم الرابع اشترى سيارة في اليوم السادس تزوج من مدينة . وسافر بها في اليوم السابع.
جمال أحمد ديني
- السبت 7 فبراير 2026