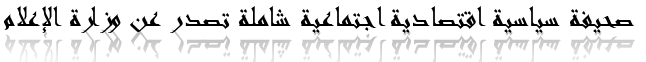هناك أسلحة ربانية جاد بها رب العالمين لهذه الأمة، وقد هدانا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديثه الشريفة، تلكم التربية التي ينبغي أن نغرسها في نفوس أبنائنا من نعومة أظفارهم، ومن يوم أن يصبحوا مميزين، ويفهموا الصواب من الخطأ، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم بها وهم أبناء عشر، وفرقوهم في المضاجع).
إن المتأمل لهذا الحديث الشريف، يجد فيه أبواباً تربوية واسعة، وأسلوباً بارعاً في تربية الفرد والمجتمع، ويرشد المختصين في مجال التربية إلى معالم واضحة ومنطلق الطريق الصحيح لإيجاد فرد سليم من كل الأخلاقيات السلبية، تلكم التربية التي هدفها توطيد علاقة الفرد مع ربه، ليرى العالم بنور الله، وينطبق عليه المثل القرآني الرائع الذي لا ينطبق إلا على من تلقى لمثل هذه التربية الإلهية، حيث قال تعالى: (كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع...) سورة الفتح الآية 29.يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن نأمر أولادنا بالصلاة وهم أبناء سبع، وحدد الحديث لهذا السن بما له من أهمية كبيرة، وما يتمتع به الطفل في هذه المرحلة من العمر من فهم وقدرة على استيعاب الأمور والأشياء، وما له من قابلية للتشكيل والتمرين، يخزن ويخرج كل ما تبرمجه من معلومات سواء كانت هذه المعلومات صحيحة أو غير ذلك.فعندما أمرنا الله بالصلاة الواجبة، أبان لنا الحكمة من إقامتها، حيث قال جل شأنه (وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر).فالابتعاد عن الرذائل، والتطهر من سوء القول وسوء العمل هو حقيقة الصلاة، والأطفال في هذه المرحلة من العمر مهيئون بكامل فوّاهم أن يقبلوا على هذه العبادة، ويفتخرون بتأديتها، ولذا نراهم في المساجد يتسابقون علي الوقوف في الصفوف الأولي، ولكن، ومع الأسف الشديد، نضربهم بالعمائم ونؤخرهم إلى الصفوف الأخيرة، فإذا شب الطفل في هذا الجو الإيماني من الصلاة والذكر، تستقيم سلوكياته عندما يكبر.أما الضرب الوارد في الحديث في السن العاشرة لم يكن أمراً يتعامل مع كل من بلغ العاشرة من عمره من الأطفال، وإنما هو بمثابة جزء مكمل من التربية، لأن الطفل في هذه المرحلة من العمر ينتقل من مرحلة تمييز مرحلة إثبات وجوده بين الناس، ومن علاماتها، العناد الشديد والمتعمد.إذن فالضرب غير المبرح، والتعامل مع الأطفال بأسلوب العصا والجزرة وارد ومقبول.
ومن الهدي النبوي في هذا الحديث، دعوة إلى أن نقدم إلى أبنائنا الجرعة الكافية من التربية الوقائية، والتي تبدأ من البيت، وبين الإخوة والأخوات، وذلك الفصل بين الجنسين في المضاجع والمراقد لقوله (وفرقوهم في المضاجع).
إنها التربية التي تمهد لهم الطريق الصحيح، وتغرس الحياء في نفوس النشأة، تزيّن الوجوه بالحشمة. إن هذا الهدي النبوي يدعونا إلى نبذ العادات الدخيلة في مجتمعنا، هذه العادات الداعية إلى الاختلاط وإلغاء الضوابط في كل الميادين والمنتديات، مما أرخى ستائر العفة والحياء في الفرد والمجتمع. فهذه التوجيهات النبوية السامية، هي الوحيدة والقادرة والكفيلة على قطع دابر تلك الأخلاقيات السافلة والدخيلة، هذه التوجيهات هي التي تحدد للمجتمع المسار الصحيح والسلوك القويم، هذه التوجيهات هي الضمان الوحيد لوضع حد لهذا المرض الفتاك (الإيدز) وتجفيف منابعه ومصادره، إذا اقتنع المجتمع بها، وآمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.إن مما يعرف به المجتمع العفيف بدينه أن يدور محور حديث شبابه حول الزواج، والتفكير به دوماً، والسعي إلى تحقيق هذا المشروع العملاق، الذي هو من فطرة الله التي فطر الناس عليها. إن المجتمع الذي لا يزال لسان شبابه وشاباته رطباً بذكر الزواج ومتعلقاته جدير أن يكون بعيداً كل البعد أن تنزلق رجله في بؤر الفساد، وأن يقع في قبضة الأمراض القاتلة والفتاكة، التي منبعها من الزنى، ولذا جعل الإسلام هذا المشروع من أوليات مبادئه السامية لصيانة المجتمع، وسهل الطريق إليه، ومهد له تمهيداً، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم) يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء).
ولكن العادات والتقاليد الاجتماعية، التي ما أنزل الله بها من سلطان جعلت الزواج عقبة كؤودة أمام بعض من الشباب الراغبين به، فلا يتجرأ أحد على اقتحام أبوابه، ووضعت سبيله إشارات المرور الممنوعة، بل بنوعها الخطير، مما جعل من الصعب العبور إلى الضفة الأخرى.
حامد علمي أحمد
- الأحد 8 فبراير 2026