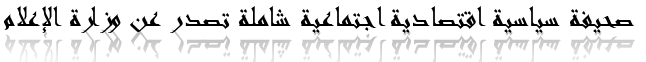وبعد عشرين عامًا، عاد زائرًا... وهناك التقى بأمي، فأنبت القدر بينهما مودةً وزواجًا.
وبفضل الله، ثم بإصرارها الذي لا يلين، حصلنا على الجنسية، والتحقنا بالمدارس، وبدأنا نشعر بطعم الحياة.
لكنّها، رغم الغياب، لم تسمح للكراهية أن تنبت في قلبي. كانت تحبب إليّ صلة الرحم، رغم أنها حُرمت منها.
حفظها الله لي، وأكرمني ببرّها كما يليق بعظمة قلبها. بقلم / حوّاء عيلترة عبسييه ( أم أفنان)