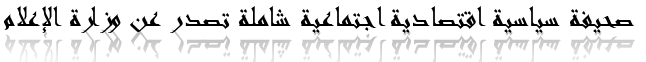وإذا دخل على المكتب أغلق الباب على نفسه كأنه لم ير أحدًا ولم يسمع شيئًا.
والأغرب من ذلك كله أن تجد أحيانًا وهو يحاول جاهدًا أن يتذكر اسمك إن لم يتناساه نهائيًا.
وبطبيعة فطرته الإنسانية، فالشخص أيا كان منصبه بحاجة دائمًا إلى الشكر والتقدير على جهوده وأدائه.